سامح المحاريق - كروية الأرض لم تكن قضية جديدة، أرسطو وصل باستدلاله إلى هذه الحقيقة وقدم عدة براهين منطقية أن الأرض تتخذ الشكل الكروي، أو على الأقل، كانت براهين قوية بأن الأرض ليست منبسطة أو مسطحة كما يبدو الأمر للإنسان القديم.
ما لم يستطع أرسطو تصوره أن تكون الأرض مجرد كوكب يدور حول الشمس، فكانت منظومته الفلكية تجعل من الأرض مركز المجموعة الشمسية، والكون بأكمله.
هذه لمحة من الغرور الإنساني، من تصور الإنسان لمركزيته في الكون، وكان العلم يمضي في اتجاهين، الأول، أن يظهر بالفعل ضآلة الإنسان وضعفه، فهو ليس مركز الكون، وغياب أي إنسان مهما يكن من أمره، لا يشكل فارقا بالنسبة للحياة فهي تمضي ولا تتوقف لأجل أحد، صحيح أن بعض البشر يمثل غيابهم إصابة لنظام معين، أو مجموعة بشرية محددة، وحتى على مجموع البشر ككل، ولكن ليس على الحياة التي تمضي دون أن تلتفت لأحد، فالأرض تواصل الدوران حول الشمس، والأخيرة تدور حول مركز المجرة، والمجرة ليست ثابتة، والإنسان ليس إلا حادثا عارضا في هذه المنظومة.
لهذا؛ من يتبنى وجهة نظر دينية، ومن يتمسك بوجهة نظر مختلفة، الاثنان يعرفان أن وجود الإنسان ليس إلا ثانية صغيرة من عمر الكون، حيث الزمن الذي نعرفه يفقد أي معنى له بمجرد الخروج من الأرض.
الاتجاه الثاني أن العلم يزيد من غطرسة الإنسان وغروره، فالإنسان لم يعد ذلك الكائن الضعيف أمام الطبيعة الذي تحصد الملايين منه مجرد فيروسات صغيرة وساذجة مثل الجدري أو الحصبة، فالعلم أعطى الإنسان جزءا من قيمته في السيرة التاريخية التي يعيشها، جعله يشعر إلى حد كبير بالسيادة، ولكن الطبيعة لا تتأخر من وقت لآخر بأن تصفع الإنسان بعنف لتجعله من جديد يشعر بعجزه.
رحلة العلم والمعرفة خلال العشرين قرنا الفائتة وصلت بالإنسان إلى حالة من الازدواجية الشديدة، الشيزوفرينيا المعقدة، فهو ما زال يحمل في فطرته كل عوامل الضعف المكبوتة والذكريات المؤسفة للبشر عبر آلاف السنين، وفي الوقت نفسه، يرى بأن العلم يسارع بتقديم الحلول، ويسرف في بذل الوعود، والحقيقة، أن الإنسان ليخرج من حالة الشيزوفرينيا عليه أن يتمسك بالجانب الروحي والتصور الشمولي للكون المنظم والذي يقبل بوجوده، في الوقت الذي يتشبث فيه بالعلم بوصفه أصلا جزءا من المسيرة والأمانة التي يتوجب على الإنسان أن يحملها، وأن يصل من خلالها إلى اكتماله، ذلك الذي يمكن أن يوصله إلى توافقه مع ذاته ومع الكون.
التناقض بين العلم والدين مسألة معقدة، وجانب كبير منها يتعلق أصلا باللغة وتفاوتها، الفرق كبير بين لغة الدين والعلم، ولا أحد من مصلحته بين المتدينين والعلماء أن يتوصل إلى لغة مشتركة، فكل فريق منهم يتمسك بموقعه الذي يضمن له تعاليا من نوع أو آخر على الإنسان العادي، وكلا الطرفان يمتلكان قدرة أعلى ليصل إلى الإعلام ويشغل الناس بأفكاره التي ليست موضوعية أو حقيقية.
يقول هنري ميللر في واحدة مونولوجاته التأملية: إن المعرفة تُثقل، والحكمة تُحزن، أما الحقيقة فلا علاقة لها بالمعرفة والحكمة. إنها خلفهما. إن بعض يقيننا يقف خلف هذه البراهين.
لا يمكن لشخص لمجرد قدرته على الظهور على الشاشة أن ينفي كروية الأرض، أو أنها تدور، هو يعتقد أن سلطته تتعلق بسيطرته على كل شيء، وبما في ذلك العلم، فلا يمكن لعلم أن يكون خارج حدود تصوره الشخصي، أما المسلمون بشكل عام فإنهم يعرفون بأن دينهم يستطيع أن يستوعب كل شيء، وأن يعيد إنتاجه، وذلك كان مصدر قوة الإسلام كمنظومة فكرية عاشت في تاريخها وتعاملت معه، وأن النص أتى دائما منفتحا على آفاق عديدة وبعيدة، والتفسيرات كانت دائما بحيث تتيح الفرصة لمعايشة أكثر واقعية لشروط العالم وأفكاره، بما يعني النقطة الوسط بين الطبيعة والإنسان، الخروج إلى حد كبير من الشيزوفرينيا المتعمقة بناء على التناقض الشكلي الذي يعتقده البعض بين الروح والمادة.
الثلاثاء 2015-02-24
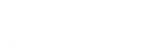





 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

المفضلات